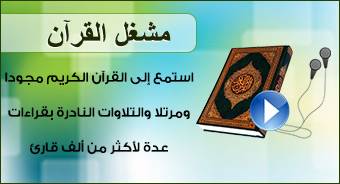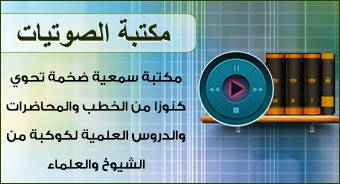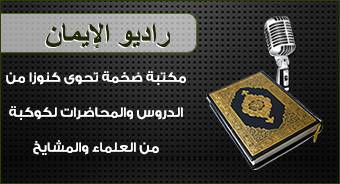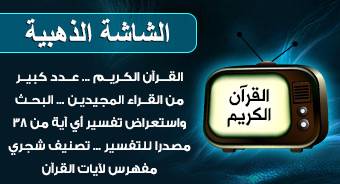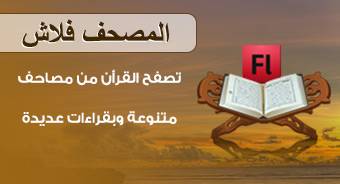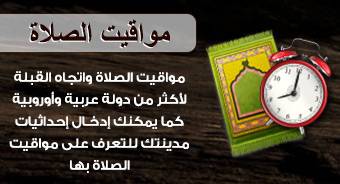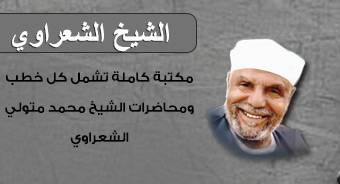|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
فمن قال إنه اسم الحوت جعل {القلم} الذي خلقه الله تعالى وأمره فكتب الكائنات وجعل الضمير في {يسطرون} للملائكة، ومن قال بأن {نون} اسم للدواة، جعل {القلم} هذا المتعارف بأيدي الناس. نص ذلك ابن عباس وجعل الضمير في {يسطرون} للناس، فجاء القسم على هذا بمجموع أم الكتاب الذي هو قوام للعلوم والمعارف وأمور الدنيا والآخرة، فإن القلم أخ اللسان، ومطية الفطنة، ونعمة من الله عامة. وروى معاوية بن قرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {ن} لوح من نور، وقال ابن عباس وغيره: هو حرف من حروف الرحمن، وقالوا إنه تقطع في القرآن: {الر} [يونس: 1، هود: 1، يوسف: 1، إبراهيم: 1، الحجر: 1] و{حم} [غافر: 1، فصلت: 1، الشورى: 1، الزخرف: 1، الدخان: 1، الجاثية: 1، الأحقاف: 1]، و{ن}، وقرأ عيسى بن عمر بخلاف {نون} بالنصب، والمعنى: اذكر نون، وهذا يقوى مع أن يكون اسما للسورة، فهو مؤنث سمي به مؤنث، ففيه تأنيث وتعريف، ولذلك لم ينصرف، وانصرف نوح، لأن الخفة بكونه على ثلاثة أحرف غلبت على العجمة، وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق والحسن: {نونِ} بكسر النون، وهذا كما تقول في القسم بالله، وكما تقول: (جبر) وقيل كسرت لاجتماع الساكنين، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم: {نونْ} بسكون النون، وهذا على أنه حرف منفصل فحقه الوقوف عليه، وقرأ قوم، منهم الكسائي: {ن والقلم} بالإدغام دون غنة، وقرأ آخرون بالإدغام وبغنة، وقرأ الكسائي ويعقوب عن نافع وأبو بكر عن عاصم بالإخفاء بين الإدغام والإظهار. و{يسطرون} معناه: يكتبون سطورا، فإن أراد الملائكة فهو كتب الأعمال وما يؤمرون به، وإن أراد بني آدم، فهي الكتب المنزلة والعلوم وما جرى مجراها، وقوله: {ما أنت بنعمة ربك بمجنون} هو جواب القسم و{ما} هنا عاملة لها اسم وخبر، وكذلك هي حيث دخلت الباء في الخبر، وقوله: {بنعمة ربك} اعتراض، كما يقول الإنسان: أنت بحمد الله فاضل.وسبب هذه الآية، أن قريشا رمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون، وهو ستر العقول، بمعنى أن كلامه خطأ ككلام المجنون، فنفى الله تعالى ذلك عنه وأخبره بأن له الأجر، وأنه على الخلق العظيم، تشريفا له ومدحا.واختلف الناس في معنى: {ممنون} فقال أكثر المفسرين هو الواهن المنقطع، يقال: حبل منين، أي ضعيف. وقال آخرون: معناه {غير ممنون} عليك أي لا يكدره من به. وقال مجاهد: معناه غير مصرد ولا محسوب محصل أي بغير حساب، وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: «خلقه القرآن أدبه وأوامره»، وقال علي رضي الله عنه: الخلق العظيم أدب القرآن، وعبر ابن عباس عن الخلق بالدين والشرع وذلك لا محالة رأس الخلق ووكيده، أما أن الظاهر من الآية أن الخلق هي التي تضاد مقصد الكفار في قولهم مجنون، أي غير محصل لما يقول، وإنما مدحه تعالى بكرم السجية وبراعة القريحة والملكة الجميلة وجودة الضرائب، ومنه قوله عليه السلام: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». وقال جنيد: سمي خلقه عظيما، إذ لم تكن له همة سوى الله تعالى، عاشر الخلق بخلقه وزايلهم بقلبه، فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق، وفي وصية بعض الحكماء عليك بالخلق مع الخلق وبالصدق مع الحق، وحسن الخلق خير كله. وقال صلى الله عليه وسلم: «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة، قائم الليل وصائم النهار». وقال: «ما شيء أثقل في الميزان من خلق حسن»، وقال: «أحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقا» والعدل والإحسان والعفو والصلة من الخلق. وقوله تعالى: {فستبصر} أي أنت وأمتك، و{يبصرون} أي هم. واختلف الناس في معنى قوله: {بأيكم المفتون}. فقال أبو عثمان المازني: الكلام تام في قوله: {يبصرون}، ثم استأنف قوله: {بأيكم المفتون}، وقال الأخفش بل الإبصار عامل في الجملة المستفهم عنها في معناها، وأما الباء فقال أبو عبيدة معمر وقتادة: هي زائدة، والمعنى: أيكم المفتون. وقال الحسن والضحاك: {المفتون} بمعنى الفتنة، كما قالوا: ما له معقول، أي عقل، وكما قالوا: اقبل ميسوره ودع معسوره، فالمعنى: {بأيكم} هي الفتنة والفساد الذي سموه جنونا، وقال آخرون: {بأيكم} فتن {المفتون} وقال الأخفش، المعنى: {بأيكم} فتنة {المفتون}، ثم حذف المضاف وأقيم ما أضيف إليه مقامه، وقال مجاهد والفراء: الياء بمعنى: في أي، في أي فريق منكم النوع المفتون.قال القاضي أبو محمد: وهذا قول حسن قليل التكلف، ولا نقول إن حرفا بمعنى حرف بل نقول إن هذا المعنى يتوصل إليه ب (في) وبالباء أيضا، وقرأ ابن عبلة {في أيكم المفتون}. وقوله تعالى: {إن ربك هو أعلم بمن ضل} الآية، وعيد، والعامل في قوله: {بمن ضل}، {أعلم} وقد قواه حرف الجر فلا يحتاج إلى إضمار فعل.وقوله تعالى: {فلا تطع المكذبين} يريد قريشا، وذلك أنهم قالوا في بعض الأوقات لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو عبدت آلهتنا وعظمتها لعبدنا إلهك وعظمناه، وودوا أن يداهنهم النبي صلى الله عليه وسلم ويميل إلى ما قالوا فيميلوا هم أيضا إلى قوله ودينه، والادهان: الملاينة فيما لا يحل، والمداراة الملاينة فيما يحل وقوله تعالى: {فيذهبون} معطوف وليس بجواب، لأنه كان ينصب. والحلاف: المردد لحلفه الذي قد كثر منه، والمهين: الضعيف الرأي والعقل، قاله مجاهد، وهو من مهن إذا ضعف. الميم فاء الفعل، وقال ابن عباس المهين: الكذاب، والهماز: الذي يقع في الناس، وأصل الهمز في اللغة: الضرب طعنا باليد أو بالعصا أو نحوه، ثم استعير للذي ينال بلسانه، قال المنذر بن سعيد: وبعينه وإشارته، وسميت الهمزة، لأن في النطق بها حدة، وعجلة، فأشبهت الهمز باليد. وقيل لبعض العرب: أتهمز الفأرة؟ قال: الهرة تهمزها، وقيل لآخر أتهمز إسرائيل: فقال: إني إذا لرجل سوء. والنميم: مصدر كالنميمة. وهو نقل ما يسمع مما يسوء ويحرش النفوس. وروى حذيفة أن النبي قال: «لا يدخل الجنة قتات»، وهو النمام، وذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الأوصاف هي أجناس لم يرد بها رجل بعينه، وقالت طائفة: بل نزلت في معين، واختلف فيه، فقال بعضها: هو الوليد بن المغيرة، ويؤيد ذلك غناه، وأنه أشهرهم بالمال والبنين، وقال الشعبي وغيره: هو الأخنس بن شريق، ويؤيد ذلك أنه كانت له هنة في حلقه كزنمة الشاة، وأيضا فكان من ثقيف ملصقا في قريش، وقال ابن عباس في كتاب الثعلبي: هو أبو جهل، وذكر النقاش: عتبة بن ربيعة، وقال مجاهد: هو الأسود بن عبد يغوث، وظاهر اللفظ عموم من هذه صفته، والمخاطبة بهذا المعنى مستمرة باقي الزمن، لاسيما لولاة الأمور.{منّاعٍ لِلْخيْرِ مُعْتدٍ أثِيمٍ (12)}قال كثير من المفسرين: الخبر هنا المال، فوصفه بالشح، وقال آخرون: بل هو على عمومه في المال والأفعال الصالحة، ومن يمنع إيمانه وطاعته لله تعالى فقد منع الخير، والمعتدي: المتجاوز لحدود الأشياء. والأثيم: فعيل من الإثم، بمعنى: آثم، وذلك من حيث أعماله قبيحة تكسب الإثم، والعتل: القوي البنية الغليظ الأعضاء المصحح القاسي القلب، البعيد الفهم، الأكول الشروب، الذي هو بالليل جيفة وبالنهار حمار، فكل ما عبر به المفسرون عنه من خلال النقص فعن هذه التي ذكرت بصدر، وقد ذكر النقاش، أن النبي صلى الله عليه وسلم: فسر العتل بنحو هذا، وهذه الصفات كثيرة التلازم، والعتل: الدفع بشدة، ومنه العتلة، وقوله: {بعد ذلك} معناه، بعدما وصفناه به، فهذا الترتيب إنما هو في قول الواصف، لا في حصول تلك الصفات في الموصوف وإلا فكونه عتلا، هو قبل كونه صاحب خير يمنعه، والزنيم: في كلام العرب، الملصق في القوم وليس منهم، وقد فسر به ابن عباس هذه الآية، وقال مرة الهمداني: إنما ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة سنة، يعني الذي نزلت فيه هذه الآية، ومن ذلك قول حسان بن ثابت: الطويل: ومنه قول حسان بن ثابت أيضا: الطويل: فقال كثير من المفسرين: هذا هو المراد في الآية. وذلك أن الأخنس بن شريق كان من ثقيف، حليفا لقريش. وقال ابن عباس: أراد ب (الزنيم) أن له زنمة في عنقه كزنمة الشاة، وهي الهنة التي تعلق في عنقها، وما كنا نعرف المشار إليه، حتى نزلت فعرفناه بزنمته. قال أبو عبيدة: يقال للتيس زنيم إذ له زنمتان، ومنه قول الأعرابي في صفة شاته: وروي أن الأخنس بن شريق كان بهذه الصفة كان له زنمة. وروى ابن عباس أنه قال: لما نزلت هذه الصفة، لم يعرف صاحبها حتى نزلت {زنيم} فعرف بزنمته. وقال بعض المفسرين: الزنيم: المريب، القبيح الأفعال. واختلفت القراءة في قوله: {أن كان ذا مال}. فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وحفص عن عاصم وأهل المدينة: {أن كان} على الخبر، وقرأ حمزة: {أأن كان} بهمزتين محققتين على الاستفهام، وقرأ ابن عامر والحسن وابن أبي إسحاق وعاصم وأبو جعفر: {آن كان} على الاستفهام بتسهيل الهمزة الثانية، والعامل في {أن كان} فعل مضمر تقديره: كفر أو جحد أو عند، وتفسير هذا الفعل، قوله: {إذا تتلى عليه} الآية، وجاز أن يعمل المعنى وهو متأخر من حيث كان قوله: {أن كان} في منزلة الظرف، إذ يقدر باللام، أي لأن كان، وقد قال فيه بعض النحاة: إنه في موضع خفض باللام، كما لو ظهرت، فكما يعمل المعنى في الظرف المتقدم فكذلك يعمل في هذا، ومنه قوله تعالى: {ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد} [سبأ: 7]. فالعامل في: {إذا} [سبأ: 7]، معنى قوله: {إنكم لفي خلق جديد} [سبأ: 7]، أي تبعثون، ونحوه من التقدير، ولا يجوز أن يعمل: {تتلى} في {إذا} لأنه مضاف إليه وقد أضيف {إذا} إلى الجملة ولا يجوز أن يعمل في {أن}، قال لأنها جواب {إذا} ولا تعمل فيما قبلها. وأجاز أبو علي أن يعمل فيه {عتل} وإن كان قد وصف، ويصح على هذا النظر أن يعمل فيه {زنيم} لاسيما على قول من يفسره بالقبيح الأفعال، ويصح أن يعمل في {أن كان}، تطيعه التي يقتضيها قوله: {ولا تطع} [القلم: 10]. وهذا على قراءة الاستفهام يبعد وإنما يتجه لا تطعه لأجل كونه كذا، و{أن كان}، على كل وجه، مفعول من أجله وتأمل. وقد تقدم القول في الأساطير في غير ما موضع. وقوله تعالى: {سنسمه على الخرطوم} معناه على الأنف قاله المبرد، وذلك أن {الخرطوم} يستعار في أنف الإنسان. وحقيقته في مخاطم السباع، ولم يقع التوعد في هذه الآية، بأن يوسم هذا الإنسان على أنفه بسمة حقيقة، بل هذه عبارة عن فعل يشبه الوسم على الأنف. واختلف الناس في ذلك الفعل، فقال ابن عباس: هو الضرب بالسيف أي يضرب في وجهه، وعلى أنفه فيجيء ذلك الوسم على الأنف، وحل ذلك به يوم بدر. وقال محمد بن يزيد المبرد: ذلك في عذاب الآخرة في جهنم، وهو تعذيب بنار على أنوفهم. وقال آخرون ذلك في يوم القيامة، أي يوسم على أنفه بسمة يعرف بها كفره وانحطاط قدره. وقال قتادة وغيره معناه: سنفعل به في الدنيا من الذم له والمقت والإشهار بالشر ما يبقى فيه ولا يخفى به فيكون ذلك كالوسم على الأنف ثابتا بينا، وهذا المعنى كما تقول: سأطوقك طوق الحمامة، أي أثبت لك الأمر بينا فيك، ونحو هذا أراد جرير بقوله: الكامل: وفي الوسم على الأنف تشويه، فجاءت استعارته في المذمات بليغة جدا. وإذا تأملت حال أبي جهل ونظرائه وما ثبت لهم في الدنيا من سوء الأحدوثة رأيت أنهم قد وسموا على الخراطيم. اهـ.
|